على مر الزمن والثقافات، كانت القصص عوامل لتغيير قُرّائها، جزئيًا؛ لأنها تغيّر عقولنا.
 (همنغواي، للمصوّر لويد آرنولد، Getty images)
(همنغواي، للمصوّر لويد آرنولد، Getty images)
في خريف 1999، سأل نورمان كونراد، أستاذ التاريخ في ثانويّة مدينة وينيون في كانساس، طلابه أن يبتكروا مشروعًا ليوم التاريخ العالمي. وخلال العصف الذهني للأفكار، صادفت إحدى طالبات الصف التاسع إليزابيث كامبيرز قصاصة قديمة من جريدة أخبار الولايات المتحدة والتقارير العالمية. احتوت على جملة تقول "إيرينا سيندلير أنقذت 2,500 طفلًا من حي اليهود في وارسو عام 1942-1943".
إليزابيث طلبت المساعدة في المشروع من زميلتها في الصف التاسع ميغان ستيوارت، وخلال وقت فراغها، غرقت ميغان في قصة إيرينا سيندلير. وتعرّفت كيف أن هذه الممرضة البولندية المتواضعة زوّرت آلافًا من أوراق الهويات لتهريب الأطفال اليهود من الحي اليهودي. وحتى تبعد الأطفال عن عيون الحُراس النازيين، خبأتهم أسفل أكوام من البطاطا وعبأتهم في شوالات.
كما أنها كتبت لائحة بأسماء الأطفال ودفنتها في جرار، بنيّة حفرها مرة أخرى بعد انتهاء الحرب حتى تتمكن من إطلاعهم على هوياتهم الحقيقيّة.
تخيّلت ميغان نفسها في مكان الممرضة الشابة، ومن خلال ذلك تمكنت من تقدير حجم صعوبة هذه الخيارات التي هددت حياة سيندلر. لقد تأثرت بشدة بمبادرة سيندلر ونكرانها لذاتها، لدرجة أن إليزابيث وصديقتيها كتبتا مسرحية عن سيندلر.
وأطلقتا عليها اسم "حياةٌ في جرّة" ومثّلتاها في المدارس والمسارح. وبعد انتشار الخبر، ظهرت جهود الطلبة في نشرهم لقصة سيندلر في قنوات CNN، و NPR، وبرنامج The Today Show.
قوّة قصة سيندلر حوّلت المشروع إلى شيء أكبر بكثير مما تخيّلته الفتاتان.
ميغان ستيوارت، التي تُعرف الآن باسم ميغان فيلت، هي اليوم مديرة البرامج في مركز Lowell Milken للأبطال غير المعروفين، وهي مؤسسة غير ربحيّة تعلّم الطلبة عن حياة الألمعيين السابقين أمثال سيندلر. "أنا مازلت أشعر بالإلهام من إيرينا سيندلر كل يوم" تقول فيلت، التي مازالت تنبهر بالطريقة التي تمكنت فيها قصة واحدة من اختراق حياتها وتغيير مصيرها بالكامل. "نريد الشباب أن يُلهَموا بالقصص التي يسمعونها، وأن يدركوا أن هم أيضًا بإمكانهم تغيير العالم".
مهمة الكثيرين من الروائيين العظماء وصانعي الأفلام مبنيّة على افتراض، سواء كان بوعي أو بلا وعي، أن القصص يمكنها أن تحفّزنا لإعادة تقييم العالم ومكاننا فيه. أبحاث جديدة قدّمت توافقًا ومصداقية لما آمن به أجيال من رواة القصص – أن الكُتب، والقصائد، والأفلام، والقصص الواقعيّة يمكنها أن تغيّر طريقة تفكيرنا، وحتى طريقة أفعالنا نتيجة لذلك. وكما وصفها الشاعر الأمريكي الراحل ستانلي كونيتز في قصيدته "الطبقات"، "لقد عَبَرْتُ حيواتٍ جمّة، بعضُها لي، وأنا الآن لستُ الرجل الذي كنتُه"*
قدرتنا على حكاية القصص، صفة بشريّة فريدة، موجودة لدينا منذ وجود قدرتنا على الكلام. سواء تطوّرت لغرض معين أو ببساطة كانت نتاج ازدهارنا في التطور المعرفي، فالقصة هي جزء لا يتجزأ من حمضنا النووي.
على مر الزمن وعلى مر الثقافات، أثبتت القصص قيمتها ليس فقط كنتاج لعمل فنيّ أو ترفيهي ثانوي، بل كعوامل في التحوّل الشخصيّ لمتلقِّي القصص.
أحد أقدم القصص التي كشفت هذا التأثير كانت العهد القديم، الذي كان مكتوبًا من بداية القرن السابع قبل الميلاد، ومن ثم تم تنقيحه على مدى مئات السنين. عندما نفكر في القسم الأول من الكتاب المقدّس، نميل إلى تذكر تسلسلاته الطويلة من "أنتَ لن.." "Thou shalt nots"، ولكن الكثير من قصص العهد القديم الأكثر هيمنة لا تحمل أخلاقيات مصرّحة بوضوح. ومع ذلك فإنّ العهد القديم عكس قيمًا وأولويات الثقافة التي نبع منها، هذه القيم وردت في حكايات مؤثرة دعت القراء والمستمعين إلى أن يتوصّلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة.
عندما تناولت حواء ثمرة شجرة المعرفة في جنة عدن، أنزلت عقاب الله عليها وعلى آدم، هذه اللوحة التي رسمتها القصة جسّدت برهبة ما ينتظر الإنسان الذي يتجاهل الأمر الإلهي. نوح، الذي نفّذ أمر الله الخفيّ لبناء سفينة، نجا من الغرق الذي تلا ذلك – وجسّد المكافآت المخبأة للإنسان الذي يُطيع أمر الله. لم يكن من قبيل المصادفة أن نشأ العبرانيون القدماء كمجتمع موحّد من الناس الذين كرّسوا أنفسهم لله ولاتباع أوامره.
حجم التأثير الهومري العظيم على غزو المدن عبر الخُدع ينعكس لاحقًا في استراتيجيات الحروب الإغريقية.

(لوحة جيوفاني تيبولي، موكب حصان طروادة، 1760، المتحف الوطني، لندن)
خلال تلك الأوقات، في الإغريق القديمة، استمر تقليد عتيق في رواية القصص المحكيّة – إحدى تلك القصص العظيمة كانت ملحمات هومر الإلياذة والأوديسة التي وُرّثت من جيل إلى جيل، وكل حكّاء كان يضيف التعديلات التي يراها مناسبة. وبالرغم من أن الشخصيات في هذه الملحمات كانت شخصيات أكبر من الحياة وواقعها، وغالبًا ما امتلكت قدرات خارقة، إلا أن الناس استطاعوا أن يتآلفوا معها. الأبطال الملحميون نادرًا ما غزو أعداءهم بسهولة. مثل أوديسيوس في شعر هومر، الذي تحمّل، هو وجنوده، رحلة مؤلمة وطويلة ليعود إلى وطنه، وواجهوا في تلك الرحلة مصاعب جمّة إلا أنهم ثابروا رغمًا عن كل التوقعات.
أحد الأسباب التي جعلت للملحمات هذا الأثر القويّ هو أنها كانت تغرس قيمًا أخلاقية مثل المثابرة، والتضحية، ونكران الذات، خصوصًا وأنّ الشباب كانوا يتعرضون لمثل هذه القيم بشكل دوري طبيعي.
في سعيهم لعيش حياة طيبة، تطلّع أجيال من الإغريق للملاحم بحثًا عن الإلهام،"الإغريقيون اللاحقون استخدموا نصوص هومر ضمن القراءات المُبكّرة، ليس فقط لأنها كانت قديمة ومُقدّرة، ولكن لأنها نصّت بوضوح مبهر على طريقة في العيش؛ طريقة في التفكير تحت الضغط" هذا ما كتبه ويليام هاريس، أستاذ الكلاسيكيات الفخريّة الراحل في جامعة ميدلبري، بولاية فيرمونت. وأضاف "كانوا يعرفون أنها ستولّد حسًا بالاستقلالية والشخصية، ولكن فقط إذا قُرأت بتمعّن، مرة تلو الأخرى."
مما أحيا طوائف تُقدّس مآثر شخصيات مثل أخيل وأوديسيوس. يشير المؤرخ جي. إي. ليندون أن أثر ما كتبه هومر في غزو المدن بالخداع ينعكس في إستراتيجية المعارك الإغريقية اللاحقة، مما يؤكد تأثير الحكايات، ليس فقط على العقول، ولكن على العادات والسلوكيات المجتمعيّة.
منذ آلاف السنين، عرفنا بشكل حدسي أن القصص تغير تفكيرنا، وبالنتيجة، الطريقة التي نتعامل بها مع العالم. لكن في الآونة الأخيرة فقط بدأت الأبحاث في تسليط الضوء على كيفية حدوث هذا التحول من الداخل. فباستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل المسح الوظيفي بالرنين المغناطيسي الوظيفي MRI أو (fMRI)، يعالج العلماء الأسئلة القديمة: ما نوع التأثير الذي تحدثه الروايات القوية حقًا على أدمغتنا؟ وكيف يمكن أن يترجم المنظور المستوحى من القصة إلى تغير سلوكيّ؟
تبدأ استجابتنا العقلية للقصة، كما تفعل العديد من عمليات التعلم، بالتقليد. في دراسة عام 2010 في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم /Proceedings of the National Academy of Sciences قام العالم النفساني أوري حسون وزملاؤه من جامعة برينستون بجعل طالبة جامعية تروي قصة عفويّة أثناء فحص دماغها بجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI. ثم قاموا بفحص أدمغة 11 متطوعًا يستمعون إلى تسجيل للقصة. وعندما قام الباحثون بتحليل البيانات، وجدوا بعض أوجه التشابه المذهلة. فور أن أضاء دماغ المتحدث في منطقة الجزيرة/Insula - وهي منطقة تحكم التعاطف والحساسية الأخلاقية – أضاءت تلك المنطقة في دماغ المستمعين أيضًا. أظهر المستمعون والمتحدثون أيضًا نشاطًا متوازيًا في الوصلة الصدغية الجدارية للدماغ، مما يساعدنا على تخيل أفكار وعواطف الآخرين. إذن بطرق أساسية معينة، تساعد القصص أدمغتنا على رسم خريطة لدماغ الحكواتي.
وما هو أكثر من ذلك، أن القصص التي نستوعبها يبدو أنها تشكّل طرق تفكيرنا بنفس الطريقة التي تعمل بها التجربة الحية.
عندما روت عالمة الأعصاب في جامعة جنوب كاليفورنيا ماري إيموردينو-يانغ سلسلة من القصص الحقيقية المؤثرة على عدد من الأشخاص، كشفت أدمغتهم أنها تتوافق مع القصص والشخصيات على المستوى الداخلي. كما رصد الناس موجات عاطفية قوية أثناء إنصاتهم للقصص– واحدة من القصص، على سبيل المثال، كانت عن امرأة اخترعت نظام برايل تبتي علمته للأطفال المكفوفين في تبت. أظهرت بيانات الرنين المغناطيسي الوظيفي fMRI أن الاستجابات التي تحركها العاطفة تجاه قصص مثل هذه بدأت في جذع الدماغ، الذي يتحكم بالوظائف الجسدية الأساسية مثل الهضم ونبض القلب. لذلك عندما نقرأ عن شخصية تواجه وضعًا يكسر القلب، من الطبيعي جدًا أن قلوبنا تنبض بقوّة. وقد علق أحد الأشخاص لـ "إيموردينو يانج" بعد سماع إحدى القصص قائلاً: "أكاد أشعر بالأحاسيس الجسديّة، هذا يشبه وجود بالون تحت عظم الصدر ينتفخ وينتقل إلى الأعلى وإلى الخارج. وهذه علامتي على وجود شيء مؤثر حقًا". هذا ما ذكرته إيموردينو يانج حسب النتائج التي توصلت إليها في دراساتها في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (Proceedings of the National Academy of Sciences) في عام 2009 وفي استعراض العاطفة (Emotion Review) في عام 2011.
نحن نتجادل مع القصص، داخليًا أو بصوتٍ عال. نرد عليها. نشيدُ. ونُدينُ. كل قصة هي بداية محادثة، مع أنفسنا ومع الآخرين أيضًا.

رصد الأشخاص الذين اشتركوا في التجربة بتفاعلهم مع القصص، مشاعر قوية من الدوافع الأخلاقية أيضًا. عندما استمع أحد المشاركين إلى قصة عن صبي صيني يقدم كعكة دافئة لأمه، على الرغم من أنه جائع جدًا، تحدث عن كيف جعله ذلك يفكر في علاقته بوالديه وحجم ما ضحوا به من أجله.
الناس توافقت بشكل مشابه مع شخصيات قصصية في دراسة أجريت عام 2013 في جامعة فريجي بأمستردام، حيث أن قراء القصص الخيالية الذين شعروا بانتقالهم عاطفيًا إلى القصة، تمكنوا من تحقيق درجات أعلى على مستوى القلق التعاطفي بعد أسبوع واحد فقط من تجربتهم القرائية.
هذا هو نوع ردود الأفعال الحسيّة التعاطفيّة التي يمكنها أن تلهم الناس بالتصرف بشكل مختلف في العالم الواقعي.
درست ليزا ليبي، عالمة النفس بجامعة ولاية أوهايو، مجموعة من الأشخاص الذين "شاركوا في تجربة" أو وضعوا أنفسهم في مكان أحد الشخصيات أثناء القراءة. حيث وجدت أن المشاركة في تجربة أو وضع نفسك في مكان أحدهم يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في السلوك. هذه كانت نتيجة دراسة ليبي وزملاؤها في عام 2012. وعندما تعامل الأشخاص مع بطل الرواية الذي أدلى بصوته في مواجهة التحديات، على سبيل المثال، كانوا هم أكثر ميلًا للتصويت لاحقًا.
من المؤكد أن الكثير من رسائل القصة لا تترجم إلى أفعال مرتّبة كما قد توحي الدراسات؛ فنحن نستجيب ليوميات آن فرانك بشكل مختلف عند قرائتها في سن 42 عامًا مقارنة بقرائتها في سن 12 عامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جميع القصص الأخرى التي اطلعنا عليها وغيرت نظرتنا في هذه الأثناء. نحن نتجادل مع القصص، داخليًا أو بصوتٍ عال. نرد عليها. نشيدُ. ونُدينُ. كل قصة هي بداية محادثة، مع أنفسنا ومع الآخرين أيضًا.
هذه الأنواع من المحادثات، الداخلية والخارجية، هي بالضبط ما يعوّل عليه المعلمون لإطلاق إمكانيات القصة على إحداث التغيير.
تنشط المؤسسة غير الربحية المسمّاة "مواجهة التاريخ وأنفسنا/ Facing History and Ourselves" في المناطق التعليمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يقدمون دروسًا للطلاب تستعرض قصصًا حقيقية من صراعات تاريخية. يقول مارتي سليبر المسؤول التنفيذي في المؤسسة "إن أكبر التحولات تحدث عندما ينخرط الأطفال بشكل فعّال – وحتى متعاطفٍ - مع سرد معين لإدراك مدى أهميته لهم. نحن نعلّم بعض الأجزاء في التاريخ التي لها صلة بالحاضر". يقول سيبلر، "نحن نبحث عن طرق يرى بها الأطفال أن التاريخ مرتبط بحياتهم".
يقدم أحد الدروس "هجمات ليلة البلّور عام "1938 بسرد تاريخي، واصفًا كيف أحرق النازيون المعابد، وحطموا النوافذ ونهبوا المتاجر اليهودية بينما كان معظم الألمان العاديون يراقبون فحسب. تحفز هذه القصة الواقعية النقاش الصفّي الذي يتطرق إلى معنى أن تكون متفرجًا؛ شخص لا يفعل شيئًا بينما يصاب شخص آخر. يفكر الأطفال في كيف سيتفاعلون مع تعرض اليهود للاضطهاد في ظل الحكم النازي، لكنهم يفكرون أيضًا في أمور مماثلة أقرب إلى المنزل، مثل ما إذا كان ينبغي عليهم الدفاع عن صديق يتعرض للتنمّر اللفظي. عندما يكتشف الطلاب أهمية القصص بهذه الطريقة، فإن أفكارهم وخياراتهم تتغير بشكل ملموس. يُظهر الأطفال الذين يكملون منهج مؤسسة "مواجهة التاريخ" مزيدًا من التعاطف والاهتمام بالآخرين، وهم أكثرعرضة للتدخل عندما يتعرض الطلاب الآخرون للتنمر.
يثبت برنامج إصدار الأحكام البديلة "تغيير الحياة من خلال الأدب" (CLTL) أن القصص المحكية يمكن أن تعيد توجيه حياة الجناة البالغين. بدأ برنامج CLTL في أوائل التسعينات من القرن الماضي ببرنامج تجريبي ضم ثمانية رجال، بعضهم متهم بعدد من الجنايات. كان الرجال يجلسون حول مائدة مع الأستاذ روبرت واكلر بجامعة ماساتشوستس، ويتحدثون عن مجموعة متنوعة من الكتب المختلفة - من كتاب جاك لندن بحر-وولف إلى كتاب تسليم لجيمس ديكي.
أثناء قراءة القصص ومناقشتها، خرج الطلاب بوجهات نظر جديدة ومدهشة.
تحدث رجل عن ارتباطه بسانتياغو، الصياد المحاصر في الشيخ والبحر لإرنست همنغواي. قال الرجل إنه شعر في بعض الأحيان برغبة جاذبة للعودة إلى إدمان المخدرات، لكن إرادة سانتياغو في المثابرة دفعته إلى مواصلة مساره ضد الإدمان. كتب واكلر يقول: "كانت الشخصية الخيالية حية بالنسبة للطالب في تلك اللحظة الحاسمة، وهي مصدر إلهام، وأصبح شخص غريب صديقًا لهذا الطالب". "لم يكن من قبيل المبالغة القول إن القصة لفتت انتباه هذا الطالب وربما أنقذت حياته في ذلك اليوم." في دراسة شملت 600 مشارك، انخفضت معدلات النشاط الإجرامي بنسبة 60 في المائة مقارنة بنسبة 16 في المائة فقط في مجموعة مراقبة.
كثير من الفنانين يشعرون بالفزع إزاء فكرة أنهم يروون القصص لحمل الناس على التفكير أو التصرف بأي طريقة معينة.
القصص التي نرويها لأنفسنا جزء لا يتجزأ من سعادتنا أيضًا. غالبًا ما يتمسك الأشخاص المصابون بالاكتئاب بالروايات الداخلية الراسخة المعيقة، مثل "لست جيدًا بما يكفي لتحقيق الشيء الكثير" أو "تقطع أمي جميع أحلامي الأكثر أهمية."
المعالجون الذين يمارسون العلاج النفسي الديناميكي يساعدون مرضاهم على التخلص من هذه المونولوجات الداخلية الراكدة واستبدالها ببدائل منعشة.
في دراسة حالة عام 2005، وصفت كارين ريجز سكاين، عالمة النفس بجامعة روتجرز، واحدًا من مرضاها، طالب دراسات عليا في أواخر العشرينات من عمره يدعى سي. جي. حيث كان طفلًا لوالدين مسيئين ومهملين. اعتقد سي. جي. أن العلاقات الوثيقة مع الآخرين لا تقدم له سوى الأذى. والعيش في إطار هذا السرد جعله وحيدًا، ومنعزلًا، ومقتنعًا أن الآخرين يسعون للنيل منه. في بداية العلاج، كان غالبًا ما يقول لسكاين "لست متأكدًا من مدى فائدة جلسة اليوم." ولكن شيئًا فشيئًا، بدأ سي. جي. في السماح لسكاين بدراسة قصصه من ماضيه الصعب. بالمقابل، ساعدته سكاين على رؤية كيف دفعته صراعاته المبكرة إلى سرد بعض القصص لنفسه مثل - العالم كان عدائيًا وباردًا، الناس سيرفضونه دائمًا - ولم يكن هذا صحيحًا بالضرورة.
في يوم من الأيام، أبلغها سي. جي. أنه سأل امرأة لتخرج معه في موعد وأنه كان سعيدًا طوال الموعد. تتذكر سكاين لحظتها كيف أنه انخرط في البكاء حين عبرت له عن فرحها بذلك، وكيف قال لها "إنه أدرك للتو أنه لم يكن هناك أي شخص في حياته يوحي له بهذا الشعور، أنه يجب أن يكون سعيدًا، وأنه ينبغي أن يفعل الأشياء التي تجلب له السعادة". لقد كانت لحظة فاصلة في حياة سي. جي. لمحة عن تطور السرد الداخلي الخاص به، أنه لم يعد الطفل المُعنّف المنسيّ، الذي رأى العديد من القوى التي تجمعت ضده، وقد بدأ يرى نفسه قادرًا وذا قيمة ويستحق الأشياء الجيدة في الحياة. وبعد أن انتهى العلاج، استمرت حياة سي. جي. بالازدهار واتخذ مناصب رفيعة المستوى في مجاله الأكاديمي.
بالطبع، يمكن لبعض الروايات الداخلية الآسرة أن تلحق الضرر بالأفق العقلي. نجاح محاولة أدولف هتلر الخطابية للسيطرة على ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي جدير بإقناعنا أن مدى إقناع السارد في ظاهره ليس في حد ذاته فضيلة. ومن المنطقيّ، أن يشعر العديد من الفنانين بالقلق من فكرة أنهم يروون القصص لحمل الناس على التفكير أو التصرف بأي طريقة معينة. كتبت شانون هيل الحائزة على جائزة نيوبري في مدونتها "غالبًا ما أُسأل: "ماذا تأملين أن يأخذ القراء من كتبك؟" "أجد صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال، لأنني لم أكتب أبدًا نحو هدف أو معنى أخلاقي. أتمنى فقط أن يأخذ القارئ ما يحتاجه".
عندما تكون القصة في أفضل حالاتها - كما يبيّن الحكّاؤون أمثال هيل – يكون تأثيرها منتشرًا وعميقًا، وليس تأثيرًا إقناعيًّا منطقيًّا.
توصف الروايات التي تخبرنا بشكل مباشر عمن يجب أن نكون، وكيف ينبغي أن نتصرف، بأنها إملائية (تملي علينا ما يجب أن نكونه أو نفعله) أو دعائية. وعلى النقيض من ذلك، توسع القصص الأكثر دوامًا نظرتنا العقلية والأخلاقية دون المطالبة بأن نلتزم بمعايير معينة، سواءً كانت تصف ممرضة شابة تخاطر بحياتها لتهريب الأطفال من حي اليهود في وارسو، أو امرأة مسنة وديعة تُظهر الحزن وقلة الحيلة بعد مأساة مفاجئة (رواية الشؤون الخارجية لأليسون لوري)،

أو مدير فندق يقوم بإيواء اللاجئين المحكوم عليهم بالموت (فيلم هوتيل رواندا لتيري جورج).
إنّ أمثال هذه القصص تقدم لنا بدائل أخرى للطريقة التي نرى بها العالم.

الأمر متروك لنا دائمًا إذا كنا سندير ظهورنا للقصة أو سنسمح لأنفسنا بالدخول في الإمكانيات الجديدة التي توفرها. ولكن عندما نقرر المغامرة في قصة غير مألوفة - كما فعلت ميغان فيلت، وطلاب واكلر، وسي. جي. - فإننا نظهر في نسخة مختلفة من أنفسنا، وربما غير متوقعة.
تسمح لنا القصص بالسفر مرارًا وتكرارًا، خارج المساحات المحدودة لما نعتقد وما نظن أنه ممكن. وهذه الرحلات - التي تكون في بعض الأحيان هشة، وفي أحيانٍ أخرى مبهجة- هي التي تلهمنا وتسرقنا من واقعنا وأنفسنا، لتأخذنا إلى مناطق مجهولة في الحياة الحقيقية.
(تم ترجمة المقال كما ورد في النص الأصلي المنشور بتاريخ 12 يناير 2015، لأغراض البحث والفائدة، لا تعبّر كل الآراء الواردة فيه بالضرورة عن آرائنا).
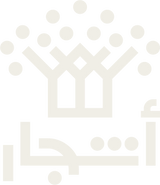
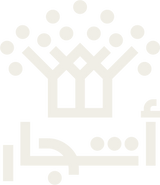

اترك تعليقًا